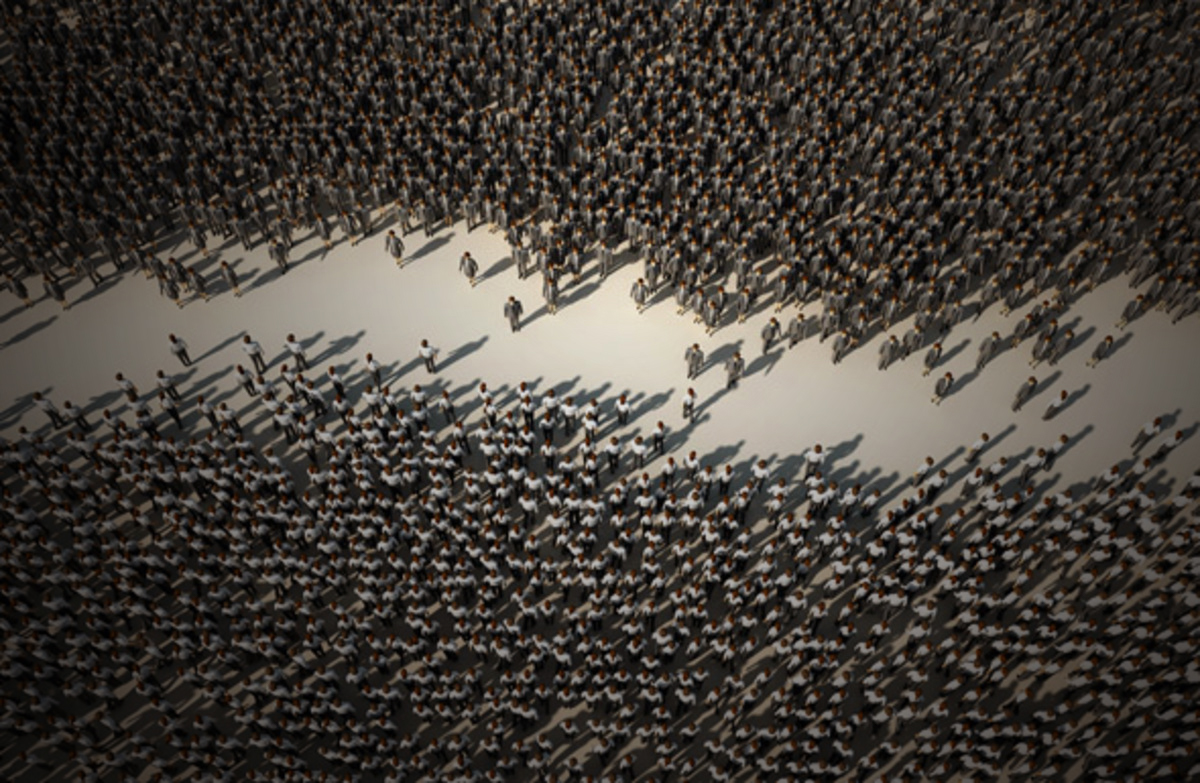يعتبر السلم الأهلي، في بلد متعدد الانتماءات والأديان والطوائف والقوميات مثل سوريا، مشروع أخلاقي وإنساني بقدر ما هو مشروع سياسي يطمح له كل عاقل في سوريا المنكوبة، وهو الأساس الذي يرتكز عليه استقرار أي مجتمع، استقرار يُبنى على إحساس المواطن وتلمسه للعدل والمساواة والحقوق في دولة ونظام سياسي قائم على التعددية السياسية والديمقراطية وحكم القانون. كما أنه إقرار وقبول مسبق من كافة مكونات المجتمع على صيغة عيش مشترك تتضمن الإقرار بأن السلم الأهلي هو البديل الضروري لثقافة العنف وخطاب الكراهية والتحريض على القتل والاقتتال ونبذ ونفي الآخر.
من يراقب المشهد العربي ويدقق بالأحداث التي تجري في البلدان العربية، خاصة البلدان التي عصفت بها رياح التغيير أو المطالبة به بشكل أو بآخر مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن ولبنان، يشعر أن ثمة مشكلة دائمة تهدد أمن واستقرار هذه الدول، حيث أن الحرب والصراع القائم في هذه البلدان وحجم العنف المنفلت، لا يعبر بالضرورة عن السلوك البشري بقدر ما يعبر عن خلل في العقد الاجتماعي ونظام العيش المشترك ودور السلطة السياسية والمجتمع عموماً في تعميق هذا الخلل. وقد شهدت تلك الدول المذكورة، وما تزال، موجة من العنف والاقتتال كانت سبباً رئيسياً في هدم عوامل السلم الأهلي المعتاد والملغوم، ومما ضاعف عملية هدم عوامل السلم الأهلي، أن العنف والاقتتال لم يقتصر على حروب تقليدية بين الجيوش النظامية، بل تعداه إلى انخراط فئات هامة ووازنة من المجتمع في الحرب، الأمر الذي جعل إمكانية إطفاء هذا الصراع صعب جدا ويتطلّب جهوداً كبيرة، هذا عدا عن أن أحد إفرازات تلك الحروب، وخاصة في سوريا واليمن وليبيا وإلى حد ما العراق، هو توجه المسؤولين السياسيين فيها إلى صرف النظر عن كل مشاريع التنمية والبناء وحصر جلّ اهتمامهم في كسب الحرب وتفادي الهزيمة وتسخير كل موارد الدولة لخدمة الحرب والدمار، الأمر الذي أفرز تدهوراً في عملة البلاد وفي القدرة الشرائية للمواطن وتدني مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة.
السلم الأهلي المصطنع:
تعيش العديد من دول العالم حالة من التنوع الديني والقومي والطائفي، وهذا الأمر ربما يكون إحدى سمات المجتمعات الحديثة، إذ يندر وجود دولة واحدة لا توجد فيها تعددية، لكن إدارة هذه التعددية والتنوع والتعامل معها من قبل السلطة السياسية والمجتمع أوصل العديد من الدول، ومنها سوريا، إلى حالة من الصراع، ذهب ضحيته الألاف من شعوب هذه الدول. إذاً، المشكلة ليست في التنوع والتعددية، بل في إدارة هذا التنوع. فالإدارة السلمية الإيجابية هي التي تجعل التعدد والتنوع نعمة وليس نقمة. وكل ذلك يعتمد على طبيعة النظام السياسي وبنيته وتداخله مع النظام الاجتماعي بسلبياته وإيجابياته.
إذا كان هناك عنوان للإدارة السورية على المستوى السياسي والاجتماعي لهذا التنوع والتعدد، فهو الفساد وشراء الذمم وخدمة المصالح الضيقة، لفئة من الناس، تحصد المال العام والوظائف الحكومية بحسب بعدها وقربها من السلطة السياسية أو تبعاً لنفوذها الاجتماعي. إذ أن السلطة السياسية ومن خلال تداخلاتها الاجتماعية استطاعت أن تفرض على المجتمع عقداً اجتماعياً سياسياً يمكن تسميته بالعقد التسلطي، فحواه إذعان ورضوخ الأفراد بالقوة للسلطة السياسية وللنفوذ الاجتماعي، وتفرّد السلطة بالقرار السياسي والأمني والاقتصادي. كل ذلك مقابل إعطاء المواطن إحساساً باستقرار المجتمع وبأن هذا الاستقرار دائم الطبيعة.
لا يمكن لهكذا سلطة مغلقة، تتمحور حول نواة صغيرة من المتنفذين في الدولة والمجتمع، وتكون فيها دائرة اتخاذ القرار ضيقة جداً، أن تستفيد من تنوع وتعدد المجتمع. لذلك وبدلاً من إدارة هذا التنوع الاجتماعي بشكل سلمي وإيجابي يحفظ لكل مكون من مكونات المجتمع حقه وخصوصيته في العيش بشكل محترم والتعبير عن هويته الدينية أو الحزبية أو حتى المناطقية ضمن الدستور، كانت الإدارة إدارة قسرية قهرية زرعت على مدى سنوات طويلة بذور التوترات الاجتماعية، التي أسست إلى تنامي خلخلة السلم الأهلي وضعضعة الإحساس بالاستقرار الاجتماعي المصطنع أصلاً. كل ذلك قاد المجتمع المتأثر أصلاً بفكرة أحقية الأقوى نفوذاً بفرض رأيه السياسي إلى النكوص والرجوع إلى مفاهيم خاوية المعنى توهم الأفراد بديمومة السلم الاجتماعي القائمة على سلطة مراكز النفوذ.
إن التعامل مع التعددية والتنوع، في المجتمع السوري، يوجب أولاً الاعتراف الواضح والصريح بكل مكون من مكونات المجتمع، مهما كان حجمه، وفتح قنوات بين السلطة السياسية والممثلين الحقيقيين لتلك المكونات؛ وذلك بهدف الوصول إلى صيغة مشتركة تضمن العيش المحترم للجميع. وهذا ما افتقدناه على مدى السنوات الطويلة الماضية. من خلال منظومة أجبرت المواطن السوري على البحث عن مظلة يستظل بها، بعد أن تم إقصاؤه وتهميشه وحرمانه من أي نوع من أنواع المشاركة، سواء السياسية منها أو الاقتصادية، فلم يجد سوى هويته الفرعية، لعله يحصل على الأمان والاطمئنان الذي يحتاجه.
دور الفعّاليات الاجتماعية السورية في تفعّيل شبكة السلم الأهلي:
يعد الصراع القائم في سوريا من أسوء الكوارث التي شهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، من حيث حجم الدمار والقتل، ومن حيث التدخلات الاقليمية والدولية التي أججت الصراع، مما أدى إلى كوارث اجتماعية واقتصادية وإنسانية، وتدهور كبير في ما بقي من الروابط والشبكات الاجتماعية. وذلك نتيجة للاستقطاب الحاد وانتشار العصبيات المذهبية والدينية والقومية، تلك العصبيات التي انتعشت نتيجة فقدان الثقة بين مكونات المجتمع وبين الأفراد وعدم الشعور بالأمان بسبب مظاهر الخطف والاعتقال والاختفاء القسري وتفشي الجريمة على نحو واسع.
بعد انهيار السلم الأهلي المصطنع الذي كان عنوان سنوات ما قبل الحرب، وفي ظل هذا الوضع الكارثي للبلد، فإن الأمر يقتضي العمل بسرعة على إعادة تفعيل العلاقات والروابط والشبكات الاجتماعية وتعزيز التعاون والتضامن بين الأفراد والجماعات على مستوى سوريا كلها، وذلك من خلال:
التواصل بين شخصيات سورية فاعلة مؤثرة، اجتماعياً ودينياً، وتتمتع بسمعة أخلاقية ووطنية وبخبرة وحكمة، للحوار والمطالبة بوقف العنف باعتباره أحد أهم العوامل التي أثرت على أمان المواطنين.
البحث مع الشخصيات الفاعلة في إنشاء شبكات أمان اجتماعية وفتح باب اللقاءات والحوارات بين الفعاليات الاجتماعية بعيداً عن العصبيات التي تكرست خلال الحرب.
العمل مع جميع الأطراف السورية على إيجاد آلية لتفعيل شبكات الأمان الاجتماعية على أرض الواقع، من خلال تشكيل مجموعات اتصال ذات مهام مختلفة، مثل المساعدة في عودة المخطوفين إلى ذويهم أو القيام بمبادرات إنسانية وإغاثية عابرة للطوائف. لأن العمل المشترك في هذه الشبكات يعزز الثقة المجتمعية بين الأفراد والجماعات، ويشيع جو من الأمان المطلوب لتعزيز المصالحة والثقة، كما أن هذه الشبكات يمكن أن تساعد، على المدى الطويل، في بناء حوارات المجتمع المدني الهادفة لتعزيز شبكة الروابط الاجتماعية وتعزيز عوامل بناء سلم أهلي متين ومستدام.
شبكات الأمان هذه ليست مشروعاً سياسياً ملحقاً بحزب أو مجموعة سياسية معينة، بل هي عمل مدني يهدف إلى تعزيز ثقافة السلم الأهلي وثقافة الاختلاف والتعددية واحترام الأديان والثقافات المختلفة.
في النهاية لا بد من الإقرار بأن سوريا تعيش حالة كارثية على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والنفسية، كما أصبحت مرتعاً لكل متطرفي العالم وبؤرة لصراعات إقليمية ودولية، وأعتقد أن العالم ليس بعجلة من أمره لإيجاد تسوية سياسية ووقف الحرب في سوريا، لذلك لا يُفيد تحميل هذا الطرف أو ذاك المسؤولية، ما يُفيد هو العمل بكل إمكاناتنا لوقف الصراع ومحاولة بناء السلم الأهلي من خلال نخب وطنية اجتماعية وسياسية، تعمل على لئم الجراح وبلورة خطاب وطني جامع.
إن الأفكار الواردة في هذا المقال تمثل فكر الكاتب ولا تعكس موقف المجلس أو الصفحة بالضرورة
بسام جوهر
ضابط ومعتقل سياسي سابق.
بسام جوهر ©